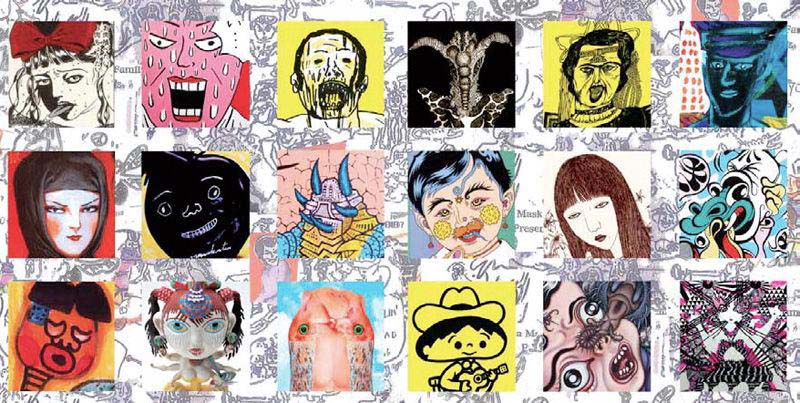Hatem Tlili : Est-il possible de mettre en place un théâtre à la fois «élitiste et populaire» ? حاتم تليلي ، ناقد مسرحي: هل يمكن إقامة مسرح “نخبوي وشعبي”؟
1)- السؤال الأوّل: يتحدّث نقاد في الخارج (مثال بول شاوول وبيار أبي صعب وغيرهما) عن أنّ “استثنائية المسرح التونسي” على المستوى العربي. أنت ناقد من الداخل: كيف ترى هذه المقولة ومدى التصاقها بالواقع وأن تكون تعبيرًا صادقا عنه؟
يجب أن نكفّ فعلا عن تسريد مقولة كهذه، إنّها تعكس ضربا من الوعي المهزوم، ذلك الذي يجد اشتغاله دوما في طبيعة النظر إلى الذّات بوصفها تعاني نقصانا مّا، بوضعها محلّ مقارنة بالآخر. طبعا، لا ينطبق الأمر على المسارح العربية وحدها في سياق اعترافها بأفضلية النموذج التونسي، فلو نظرنا مثلا إلى التجارب المسرحية في تونس مقارنة بقريناتها الغربية لحدث نفس الأمر. على الأرجح، إنّ الإقامة عند حدود هذا الاستشكال المسرحي لهو ضرب من السكن القديم في سياق نشأة هذا الفنّ الوافد وضروب تأصيله. ثمّ إنّ الجدل الذي أحدثه لم يكن محرّكه الوحيد غير ذلك المنهج المقارني. مقابل ذلك، علينا الاعتراف بأنّ الجدل يبنى على التناقض لا على المقارنات، إذ لكلّ تجربة مسرحيّة وضعها الاشكالي المخصوص. وإذا ما أردنا وضع تجربتنا المسرحية على طاولة التشريح الآن، فسنكتشف حتما أن مسرحنا يعاني من أورام عديدة هو يبدع بشكل عظيم في التكتّم عنها، وإلا كيف نفسّر ذلك الانفجار المدوّي لعدد النقابات المتكلّمة باسمه؟ وموجة الانتحال التي نزلت به؟ وسياسات الدّعم القائمة على المحاباة؟ وتخبّطه في دهماء الجماليات؟ وخلفياته الفكرية الذي ذهبت إلى جعل الله حتّى مجرّد أصل تجاري؟
إنّنا لا نرمي إلى شطب مسارات هذا المسرح بقدر ما نلمّح إلى ضرورة تأسيس سردية نقدية تعصف بضروب الوهم الذي لحقه، خارج مقولات بائسة تضعه في أفق مقارني، فما معنى مثلا أن نستعمل هنا هذه العبارة اللغوية “المسرح التونسي”؟ ألا يمكن تغييرها بعبارة أخرى “المسرح في تونس”؟ وألا تعدّ – في المقابل-، عبارة “المسرح العربي” ضربا من العبث اللاهوتي والأنتروبولوجي في أفق مجتمعاتنا وهي تسعى إلى تحطيم هالة الحاكم الهووي؟ يجب فعلا تدمير هذه الأجهزة المفهومية التي اخترعها نوع من النقاد البرابرة، أولئك الذين لا مهمّة لهم غير حراسة القوافل المسرحية المهاجرة من مهرجان إلى آخر. إنّنا ننتقل بشكل عنيف وعظيم إلى السكن “في قرية العصر الإمبراطوري”، حيث تتشظّى الهويات والأعراق والثقافات ومن ثمّ نجد لها تسريدا ممسرحا يتخطّى الجغرافيا والحدود ويتحرّر من جهاز الانتماء إلى “الوطن والملّة والهويّة”. بدلا من ذلك: لا أفق يهاجر إليه غير الانسانية. لقد كان أجدر بالنسبة إلى أولئك النقاد أن يطرحوا الأسئلة الأكثر هوسا بالمستقبل: أيّ مسرح يجب أن ننجزه في سياق المنعطفات الابستيمولوجية العنيفة التي يمرّ بها العالم الآن؟
2)- هناك “مسرح النخبة” في تونس (الجعايبي ـ الجبالي ـ إدريس وغيرهم) مقابل “مسرح العامّة” (الوان مان شو) المعتمد على التهريج والإضحاك من خلال التنكيت. ما الذي يربط بين العالمين وما الذي يفرّق؟
اسمح لي قبل تقديم اجابة جاهزة بطرح سؤال مغاير: هل من الممكن التفكير في إمكانية تقديم مسرح (نخبويّ للجميع)؟ تجدر الاشارة إلى أنّ العبارة الواردة بين قوسين تعود إلى “أنطوان فيتاز A.Vitez”. طبعا، ليس هذا مجال الاشكال الذي نرمي الخوض فيه، إذ نحن معنيون بالأساس بمساءلة واقعة مسرحية بعينها، تلك التي تجد اشتغالها ضمن سياسات التلقّي المسرحي وطبيعة الجمهور المستهدف منها. يمكن ببساطة الانحياز جماليا ومعرفيا مع ما يصطلح عليه بمسرح النخبة، لكن ما مدى تأثير هذا المسرح على الصعيد الاجتماعي والحال أنّ جمهوره هم المسرحيون أنفسهم وبعض من المثقفين لا غير: إنّ هذا المسرح الذي نشاهده في تلك القاعات المغلقة لا يتعدّى تأثيره حدود ذلك العدد القليل من متابعيه. في المقابل: ثمّة جيوش من أفراد الشعب العالقة في شراك العنكبوت اللاهوتي وحيف التطرّف الأصوليّ كان ممكنا إعادة هندسة عقولها وتربية أرواحها من جديد. صحيح أنّه ليس من واجب المسرح الاعتناء بالحالة الاجتماعية الظالمة إذ المدفع أجدر بذلك كما يتحدّث “أنتونان آرتو”، ولكن ألا يعني ذلك توصيف مثل هكذا مسرح بأنّه أسير تلك الفضاءات المغلقة أين يلوك المثقفون هزائمهم ويعبرون عن سخطهم من الراهن السياسي والثقافي والاجتماعي دون انغراس أنثروبولوجي في بيئتهم؟
فيما يخصّ التعليق على ما تمّ الاصطلاح عليه بمسرح العامّة، ذلك الذي يتّخذ من التهريج عنوانا له، يجب أن نعقد معه حربا لا تنتهي إلا بتصفيته، فهو صيغة مبتذلة ومنحطّة عن الكوميديا في مفاهيمها ووظائفها النقدية والتهكمية والساخرة، ولا هدف لأصحابه منه غير منطق السوق. إنّه مسرح قائم بالأساس على ما هو تجاري مهما كان وضعه الجمالي، بقدر ما يصيّر المعنى عدما يسعى دائما إلى الانحطاط بالعقول وتكريس المبتذل والرديء: هذا ما يمكن أن نرجعه إلى تحطيم هالة الفنّ وسلعنته. طبعا، يبدو أنّ الجمهور المسرحي بات على يقين واضح بأنّه ثمّة صحراء زاحفة إلى هذا الفنّ، لقد قرّر بدوره الهجرة خارج كروم هذا الفنّ، وبخاصّة بعد سكنه قرى التكنولوجيا والديجتيال: ليس ثمّة رابط بين العالمين إلا ذلك الجمهور الذي سئم تفاهة تلك المسكّنات التي نبيعها له، فهو الذي يتصادم مباشرة مع غوائل الحياة فصار المسرح عينا له.
3)- في خضم التحوّلات التكنولوجية الكبرى، وانتقال الفرجة من السينما والتلفزيون إلى الهاتف واللوح المحمول، أي مكان وأي مكانة للمسرح على اعتباره “الفنّ الرابع”؟
نعم، ثمّة الآن أصوات تعبّر عن مخاوفها من أفول هذا الفنّ ونهايته. لقد كان الأجدر بها أن تتحدث عن نهاية تاريخ المسرح لا نهاية المسرح عينه. لقد وجد هذا الفنّ ليكون مرتبطا بشكل عميق بالدم. ما نقصده هنا هو استحالة الحديث عن فنّ مسرحي دون حضور الآدمية على الركح، ثمّ إنّه أكبر عمرا من الاله التوحيدي نفسه، ولن ينتهي إلا بنهاية الانسان. على الأرجح، إنّ ما يموت في المسرح هو أشكاله وامكانيات وجوده القديمة. أمّا أن نتحدّث عن مكانته في سياق التطوّر التكنولوجي المتسارع والمرعب فهذا عائد إلى طبيعة سكنه مدن العالم، من حيث فضاءات العرض وقضاياه التي تنعطف إلى أفق ما بعد موت السرديات القديمة، تلك التي تمّ الاعلان عن موتها من قبل العديد من المفكرين ومن بينهم الفيلسوف الفرنسي “ليوتار” والأمريكي من أصول مصرية “ايهاب حسن”. دون شكّ، يتوجّب علينا أن لا نفهم “المابعد” بوصفه قطيعة نهائية مع الماضي أو الحاضر، على العكس من ذلك: إنّه ضرب من العودة إلى “الماقبل” واستدعاء للثقافات الغابرة قصد تدميرها وإعادة نسجها من جديد كضرب من إعادة تشغيل السؤال عن كيف يمكن اختراع مستقبل جدير بالسكن المشترك، هكذا ندرك الأمر مع “ليندا هتشيون” في كتابها “سياسات ما بعد الحداثية”.
لا يتوجّب في حالة كهذه السؤال عن مكانة المسرح، بقدر ما يجب توجيهه على النّحو التالي: كيف نكبح المسرح فلسفيّا كي لا يتوغّل عميقا في التّيه؟ وكيف يمكن التعويل على هذا الفنّ في أفق الدّفاع عن النّوع البشريّ أمام مخاطر التكنولوجيا؟ وكيف له أن يستقرّ بهدم نفسه وتجديدها بتجدّد اهتمامات هذا الكائن الآدمي؟
4)- نشهد في العشرية الجارية دخولا لفنون أخرى إلى المسرح، مثل الشاشة على الركح. هل هذه موضة، تلويث أم فعل طبيعي بحكم تطوّر العصور والتكنولوجيا والفنون.
هذا الأمر ليس جديدا على المسرح، فهو من أكثر الفنون جشعا واستثمار للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا. وما انعطافه الآن على النّحو إلا ضرب من ضروب الإقامة في ضدّه النّوعي. فمنذ عصور خلت كانت ثمّة سردية المزارع الحزين، تلك التي اخترعت لها أفقا ميثيا وأسطوريا وجد شكله في الصخب الباخوسي أين تتمّ عملية تسريد الاحتفالات الجماعية، ومنذ نشأة مدينة اللوغوس الاغريقية تمّت مأسسة هذا النّوع الفرجوي ليوجد هذا الفنّ، ومنذ أزمنة ليست بعيدة تمّت الثورة على أدبية المسرح والإعلان عن موت المؤلّف، وهاهي أصوات الآن تنادي بموت المخرج ومولد السينوغراف. تكمن عظمة هذا الفنّ في قدرته المدهشة على اختراع ضدّه النّوعي كلّما اقتربت ساعة نهايته. ولكن علينا الانتباه هنا إلى راهنه المتعلّق بحضور التكنولوجيا بشكل عامّ: لقد سبق أن عوّض “كوردن كريك” الممثّل بالدمى، كما وجدت بعض التجارب التي قدّمت عروضها في فضاء مخصوص معيّن والحال أن ممثّليها في أمكنة مغايرة تماما، ونجحت في ذلك نظرا لحكمة المكر التكنولوجي. الأمر هنا ليس موضة أبدا، بل هو أشبه بإقامة هذا الفنّ في “فضاء مجنّح” يكون فيه المتلقي بدوره كائنا افتراضيا، ولكن هل سيصحّ اطلاق تسمية المسرح على مثل هذا النّوع من التجارب وهي التي تهدف إلى إقصاء الآدمية منه؟ يجب في حالة كهذه عقد صرامة مفهومية بين الفنّ المسرحي كواقعة مخصوصة والأشكال الفرجوية والتعبيرية والأدائية الجديدة.
في المقابل، علينا الانتباه إلى ظاهرة تجد تسريدها الآن في نماذج من تجارب بعض المسرحيين في تونس أو غيرها من الدول العربية، إنّها تحاول بشكل هستيري توظيف هذه التقنيات الحديثة، ومردّها في ذلك ليس تلك الخلفيات الجمالية التي تسعى إلى عقد ضرب من المحاورة بين هذا الفنّ وما يرفده إلى عوالمه، بقدر ما هي تحاول بشكل أو بآخر تقديم نفسها على أساس أنّها الأسبق في ذلك، فلا هي لامست التجريب أو التجديد ولا هي حازت على ذلك الشرف. ثمّ إنّ ذلك لا يمكن أن يتحقّق اطلاقا بمعزل عن المعدّات والامكانيات التقنية لصالونات العروض، وهنا سيصبح الأمر مثابة عبث ضاحك حين نتأمّل تلك الفضاءات المسرحية المتداعية والخربة في مدننا.
, critique théâtral
La page facebook de Hatem Tlili : https://www.facebook.com/hatm.mhmwdy
A voir aussi sur artsixMic :
لماذا المسرح؟
L’Hiver à Moscou by Anna Pavlikovskaya
Célébration du Rams Road : Le Chemin de Dieu
Une escapade arty sur la Côte de Granit Rose
Morzine, une destination chaleureuse de qualité
Au coeur du Wadi Rum, le Yasmina Luxury Camp !
Voyage en Equateur avec Elizabeth Rojas Gilliand
La ville-état de Singapour : La ville-jardin !
Vichy : La reine des villes d’Eaux !
Savoie Mont Blanc : Cet hiver, c’est ouvert !
Joyau du Pacifique Sud : la Nouvelle-Calédonie !
Novi Sad capitale européenne de la culture 2022